
|
| س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | بحبشة و نكوشة | مواضيع اليوم | أشرلي عالشغلات يلي قريانينها |
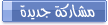
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 | ||||||
|
مشرف متقاعد
|
بقلم: ياسين الحاج صالح *
أقدر للأستاذ إسماعيل أحمد مبادرته إلى التعليق على مقالي "موقع الثقافة في مشروع الإسلاميين السوريين" الذي نشر في جريدة "السفير" البيروتية (وليس "النهار" كما ورد في مقاله) في 22/1/2005 (إسماعيل أحمد: "هذه ثقافتنا يا استاذ ياسين" في موقع أخبار الشرق في 2/2/2005، وكان المقال قد نشر قبل ذلك في موقع الرأي بعنوان: هذه هوية أمتنا التي نستمسك بها، وهذه ثقافتنا). وأحيي إقراره المباشر بأنه يرد "كإخواني من شباب هذه الجماعة المباركة". أعتقد أنه تحدونا معا رغبة في الحوار والتواصل كمواطنين ومهتمين بالشأن العام في بلدنا، رغم اختلافنا السياسي والإيديولوجي. ويقيني أن هذه الرغبة ليست فضيلة أخلاقية قد نتحلى بها فقط، وإنما هي ضرورة حيوية لبلدنا. فتواصل وتفاهم وتعارف السوريين المختلفين هو المؤشر الأول على نضجهم السياسي، وارتفاعهم عن السوية الحضارية والأخلاقية المتدنية للاستبداد الحاكم وضمان لمستقبل بلدهم. بهذه الروحية سيعلق هذا المقال على ما كتبه الأستاذ أحمد. ومن أجل تنظيم التفكير فإني سأتناول ثلاثة مفاهيم وردت في عنوان مقاله، وتتكثف فيها وجوه الاختلاف بين مقاربتينا: مفاهيم الهوية والثقافة والأمة. تملك خاص للأمة: ألاحظ في البداية ان العنوان الذي وضعه الأستاذ أحمد (الصيغة التي نشرت في موقع "الرأي": هذه هوية أمتنا التي نستمسك بها، وهذه ثقافتنا) ينطوي على تملك خاص للمفاهيم الثلاث، وتالياً على إقصاء من لا يشاركه فكرته عن الهوية والأمة والثقافة. وهذا في رأيي يتعارض مع الشراكة في البلد وفي المواطنة، فلا أحد منا ضيف عند أحد، ولا أحد ينال حقوقه تنازلاً تفضلاً من أحد؛ كما أنه يطابق منهج السلطة التي نشترك، الأستاذ أحمد وأنا، في اعتراضنا عليها وفي تحملنا الكثير جراء موقفنا منها. ففلسفتها لا تقول شيئاً آخر غير أن "ثقافتنا وهويتنا وأمتنا" هي التي تعبر هي عنها، بل هي وحدها التمثيل الأمين لها ولتاريخنا وخصوصيتنا، إلى درجة ان النظام يستنبط ذاته بالتمام والكمال من ثقافتنا وهويتنا وتراثنا. وهو ما يعني ان مقام الأستاذ احمد في المنفي وسابق مقامي في السجن؛ هما تجليان لهويتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الحضارية المهددة حسب النظام البعثي الحاكم. والواقع أني أجد الأستاذ احمد يستند إلى ما أسميه ثقافة الطوارئ ذاتها التي يحكمنا "حزب البعث" وأجهزته باسمها، لكن طوارئ الإسلاميين ثقافية أولاً، بينما هي سياسية وعسكرية أولاً عند البعثيين ومجمل القوميين، وأكثر الشيوعيين، فالأمر يتعلق بثقافة سياسية مشتركة راسخة بعض الشيء وليس بإيديولوجيات ولا بمواقف سياسية متحولة. ورأيي ان موقفنا متهافت حين ندعو إلى إلغاء حالة الطوارئ، بينما نستند إلى ثقافة الطوارئ (المرحلة حرجة، والأخطار محدقة، والغزو الثقافي داهم، والعدو على الأبواب، إلخ.. إلخ). ينبغي ان يكون هذا بديهياً. إلى ذلك، فإن عنوان مقالة الأستاذ أحمد يفيد في إغلاق النقاش لا في فتحه، وفي إقصاء كاتب هذه السطور وأمثاله لا في مشاركتهم والحوار معهم. فهو يقول: هذه ثقافتنا وهذه هوية أمتنا، وليس هذا تصوري أو تصور الإخوان المسلمين عن هويتنا وثقافتنا. ومن المفهوم أن يكون من يعارض الأستاذ أحمد خارجاً على هوية الأمة وثقافتها. ترى ما هو المعادل السياسي لهذا الكلام؟ لا شك لدي أن الأستاذ احمد يريد لي ولمخالفيه الآخرين خيراً، لكن المسألة ليست في النيات الذاتية، بل في الإشكاليات الفكرية والسياسية. إشكالية أحمد استئثارية وإقصائية: تستأثر بالحقيقة وتقصى المخالفين. وعند الممارسة تنفجر التناقضات الموضوعية التي كانت تخفيها النيات الذاتية المخلصة، وانفجارها يودي ببشر ملموسين وليس بافكار وآراء مجردة. هويتنا هي ما نفعل لا ما نرث: في غير موقع من مقاله يتحدث ناقدي عن هوية الأمة، ويقرر أنها ليست "عرضة للمساومة سواء قبلنا بها أو رفضنا برنامج هذا الفصيل أو ذاك". هذا إضفاء للقداسة على "هوية الأمة"، لا أجد له سنداً في العقل ولا في التاريخ ولا في الدين. ولسبب ما، يعتقد الأستاذ احمد انه اقرب إلى "هوية الأمة" من منقوده. وأميل إلى ان السبب في ذلك افتراضه أن هوية الأمة هي دينها (دين أكثرية أفرادها في الواقع)، وأن انتماءه إلى حزب سياسي يسعى إلى رسملة الدين والتراث الحضاري الإسلامي والعربي سياسياً يجعل منه أحق بهما من غيره. لا أوافق على شيء من ذلك، وبالخصوص ان المشروع الذي انتقدت غياب مفهوم الثقافة عنه يقول إن الجماعة التي أصدرته هي جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين. لا أوافق على ذلك أيضاً، لأن الإخوان المسلمين في سورية وغيرها حزب سياسي قبل أي شيء آخر. إن مطابقة سياسة الحزب مع الدين الإسلامي أمر يحق لأي كان أن يجادل فيه، سواء كان من وجهة نظر إسلامية أخرى أو من وجهة نظر التحليل السياسي والاجتماعي. إلى ذلك، فإن الأستاذ أحمد يتحدث عن مفهوم مجرد وخلافي هو الهوية (هذه هويتنا) بطريقة تملكية تناسب المحسوسات والمحسومات. والحال أن الهوية المحسوسة المحسومة هي هوية شعب منقرض، هوية صمتت وآلت إلى آثار وماديات. أما هوية الشعوب الحية فهي هوية حية وتاريخية. هويتنا ليست معطى ثابتاً وفوق تاريخي. هويتنا ليست قدراً لا يحول ولا يتبدل. هويتنا ليست ما فعله تاريخنا بنا، بل ما نفعله بهذا التاريخ وما نفعله في هذا التاريخ. وهي ليست جوهراً ثابتاً متعالياً على الأزمنة، ولا معدناً نقياً يشبه ذاته دوماً ولا يختلط بغيره. وتكون الأنظمة أشد استبداداً حين يتم تسييس الهوية على النسق البعثي السوري والعراقي، الذي يعترض عليه الأستاذ أحمد سياسياً، لكنه في الواقع يستنسخه فكرياً. ذلك أن هوية المجتمعات لا تنفصل عن وجودها التاريخي النثري والتحول الذي نراه ونعيشه، وهذا المفهوم غير قابل للتسييس. فما يسيسه المسيسون هو مفهوم للهوية فصل عن حياة الناس ووجودهم التاريخي وفرض عليهم بوصفه روحهم الحقيقية. يقول الإسلامي إن هذه الروح هي الإسلام، وإن الإسلام هو تأويله هو له. ويقول البعثي إن العروبة هي هذه الروح، وإن العروبة هي ما يفعله هو. غير ان هذا باب للانقسام لا للوحدة، وللاستبداد لا للحرية، وللتمييز بين الناس لا للمساواة. فلا يمكنك تسييس الهوية وإبقاؤها عنواناً للوحدة في الوقت نفسه. إذا قرأ الأستاذ احمد ثلاثية نجيب محفوظ، سيجد وضعاً للمرأة أشبه بوضع الأمة، وسيجد أن زوجها (سي السيد) صاحب سلطة مطلقة عليها. هل دونية المرأة وخروجها من بيتها مرتين، مرة نحو دار الزوج ومرة نحو الدار الآخرة، هو هويتنا؟ وإذا قرأ رواية "قلب من بنقلان" التي صدرت عام 2004 لسيف الإسلام بن سعود بين عبد العزيز آل سعود، سيجد صفحة من تاريخ السعودية كان الرق وتجارة الرق شيئاً طبيعياً فيه، إلى درجة أن تحريم الرق الذي جاء نتيجة ضغوط دولية أثار امتعاض رجال الدين. هل تجارة الرق أم تحريمه من هويتنا؟ في رأيي أن الإسلام كسب ولم يخسر من طي صفحة العبودية والوضع الدوني المطلق للمرأة. وأصارحك القول: إنه سيكسب وسيزداد رفعة ونقاء مع حظر تعدد الزوجات وتراجع الحجاب، بل ومنع الأذان لصلاة الصبح عبر مكبرات الصوت .. وإذا تحولنا من علاقة الهوية بالتاريخ، وقد رأينا أنها متحولة وتاريخية هي ذاتها، إلى علاقتها بالمجتمعات الملموسة والحية نتبين أنها مركبة واستيعابية ومفتوحة على التهجين والاستعارة والتمثل والعدوى. هل ترتد هوية سورية اليوم إلى العنصر الإسلامي أو العربي الإسلامي فحسب؟ ماذا نفعل بالعناصر غير العربية وغير الإسلامية، وبعضها قبل عربي وقبل إسلامي، وبعضها حديث معاصر؟ أي العناصر أكثر مطابقة لهوية سورية: العنصر البدوي أم المديني أم الفلاحي؟ كان إسلام بلاد الشام مدينياً أساساً، لكن هل يعني أن الإسلام البدوي والفلاحي غير مقبولين؟ وماذا عن الإسلام غير السني: العلوي والإسماعيلي والدرزي؟ عقيدياً، كل منها بعيد عن الإسلام السني، لكنها تنتمي جميعاً إلى المجال الحضاري الإسلامي الذي تفاعلت فيه مواريث إسلامية ومسيحية ويهودية، ويونانية وهندية وفارسية قديمة. إن أي مفهوم واحدي للهوية سيفضي حتماً إلى مشكلة سياسية متفجرة (فضلاً عن الإفقار الثقافي). فإذا كان إسلامياً، فسيقصي المسيحيين واليزيديين، واذا كان عربياً سيقصي الأكراد والأرمن والشركس. وما دمنا بصدد الحديث عن سورية وعن مشاريعنا السياسية والحضارية لمستقبلها، فقد يكون علينا أن نبلور مفهوماً للهوية الوطنية السورية يستوعب التعدد الإثني والديني والمذهبي، وتكون المساواة وحرية الاعتقاد ركنيه الجوهريين. ومن نافل القول أن استيعاب التعدد غير ممكن على أرضية دينية أو قومية محددة. من نافل القول أيضاً أن المساواة دون حرية اعتقاد تكون قناعاً للامساواة، وأن حرية الاعتقاد الديني وغير الديني ينبغي أن تكون متكافئة للجميع. الأمة العقيدية والأمة التعاقدية: يستخدم المشروع والأستاذ إسماعيل أحمد مفهوماً غير واضح للأمة. هل هي الأمة السورية أم الأمة العربية أم الأمة الإسلامية؟ وهل هذه هي أمة المسلمين البالغين ملياراً وربع، أم أمة المؤمنين الهداة فحسب؟ وحين نقول ثقافة أمتنا أو هوية امتنا أو ثوابت أمتنا، هل المقصود أمة تعاقدية أم أمة عقيدية؟ كاتب هذه السطور عربي وعروبي، لكنه يعتقد أن مفهوم الأمة السورية مشروع فكرياً وسياسياً. فليس غير هذا المفهوم يمكن توحيد السوريين على أرضيته. ويبقى هذا صحيحاً حتى لو كان جميع السوريين عرباً ومسلمين وسنيين، ذلك أن مقام المواطنة مستقل عن مقام الإيمان، دون أن نفتعل خصاماً أو تعارضاً بينهما. وإلى المقام الأول تنتمي مدركات الحزب السياسي والتعاقد والهوية المركبة والديمقراطية والدستور وتداول السلطة، فيما تنتمي إلى المقام الثاني قيم الأخوة والهداية ورفقة الإيمان التي يخبرها الناس في الصلاة أو في الحج أو في السجن. وبالطبع، قد يشارك المرء في الأمتين، أمة المواطنة وأمة الإيمان، أو أمة التعاقد وأمة العقيدة، دون أن يعني ذلك أن المقامين متطابقان. فليس ثمة ما يمنع المواطن أن يكون مؤمناً، وليس ثمة ما يحتم على المؤمن أن يرفض المشاركة مع مؤمنين أو غير مؤمنين في شراكة سياسية وحقوقية متساوية، أي في المواطنة. لعلنا، الأستاذ إسماعيل أحمد (والأستاذ محمد وليد الذي انتقد مقالي نفسه من موقع مطابق لموقع الأستاذ أحمد في مقال له بعنوان "وللثقافة شجون" في أخبار الشرق، 17/2/2005) وأنا شركاء، في أمة المواطنة والتعاقد المحتملة، ونحن الآن "شركاء" في افتقارنا للحقوق التعاقدية للمواطنة في بلدنا سورية. هذا لا يقتضي بحال شراكة إيمان وعقيدة. هل يشرط الأستاذان شراكتنا التعاقدية بشراكة عقيدية؟ هذا سؤال عليهما وعلى الإسلاميين السوريين الإجابة عليه بوضوح تام. وخلافاً لما يخشى الإسلاميون، وخلافاً لما قد يأمل علمانيون متطرفون لم ينتقدوا علمانيتهم، فإن العقائد الدينية تعيش أبهى أيامها في ظل السياسية التعاقدية والمدنية، أعني السياسة التي ترى في حرية الاعتقاد شرطاً لكل اعتقاد. وهو ما يعني أن الأمة العقيدية تكون بأحسن حال في ظل الأمة التعاقدية، وأن المطابقة القسرية بين العقد الإيماني مع الله والعقد السياسي بين الناس إساءة للعقد الأول وإفساد للعقد الثاني. إن الدولة التي تحرس الدين، هي الدولة التعاقدية وليس الدولة الدينية، الدولة التي يتوافق على تنظيماتها أفراد يتمتعون بحرية اعتقاد متكافئة، مع ما يعنيه ذلك من حرية عدم الإيمان، أي باختصار دولة الحرية. بعبارة أخرى: لا يحرس الدين غير حرية الاعتقاد أو الحرية الدينية، أما المفهوم الذي يستخدمه المشروع، والمأخوذ من الماوردي، فلا يبرره التاريخ. الواقع أن الدولة في تاريخنا الإسلامي كانت عبئاً على الدين، كان معظم السلاطين والخلفاء فاسدون من وجهة نظر إيمانية، ربما كان بعضهم عظماء كرجال دولة، ربما كان بعضهم محاربون من أرفع طراز، ربما بلغت الحضارة الإسلامية ذروة رفيعة في عهد بعضهم، لكن إيمان المسلم المتوسط أو المسلمة المتوسطة اليوم أنقى من إيمانهم وأصفى. إلى ذلك، فإن الإسلام اليوم ملاذ من طغيان السلطة وتعسفها، فإذا توحدا كانا سلطة ساحقة ثقيلة الوطأة وخطراً على الحرية والإيمان معاً. ثم إن توحدهما يجعل من الخروج من الدين وعليه الشكل الوحيد للاعتراض السياسي. في جمهورية إيران الإسلامية، حيث تتوحد السلطتان الدينية والسياسية، كف 75 في المائة من الناس عن الصلاة و86 في المائة من طلاب الجامعات. وفي سورية البعثية، كم نسبة من يؤمنون بالعقيدة البعثية؟ وكم نسبة الذين كفروا بالعروبة التي جعلها النظام ديناً رسمياً وجعل من الاعتراض عليه خروجاً عليها؟ هذه ثقافتنا أيضاً! أكثر ما أثار ناقدي هو مفهوم الثقافة في مقالي. أود بداية أن أبدد سوء فهم أو تفاهم. يعتقد الأستاذ إسماعيل أحمد بأن مفهوم الثقافة كخصوصية أو كتراث أو كهوية أو حتى كحضارة لا يعجبني. هذا تجن وتسرع. ففيما عدا أن الإعجاب وعدم الإعجاب غير واردين في مقام كالذي نتناقش فيه، فإن ما قلته في مقالي هو أن مفهوم الثقافة الغائب عن مشروع الإسلاميين هو مفهومها كإبداع وليس كتراث وخصوصية .. إلخ. نعم الثقافة تعني التراث الذي ترثه أمة من ماضيها، وتعني الهوية التي تميزها عن غيرها، وهي منبع خصوصية العرب بالمقارنة مع الفرنسيين والصينيين، والأكراد عن العرب والترك .. (ليس ثمة خصوصية غير مقارنة)، وبعض الدارسين يقيم ترادفاً بين الحضارة والثقافة، ويرى أن كل ما اكتسبه الإنسان من حياته في مجتمع هو ثقافة، سواء كان تقنيات أو تنظيمات أم قيماً وعقائد. هذا كله ثقافة، وكله "يعجبني"، إذا كان الأستاذ إسماعيل أحمد مصراً على معرفة موقفي. لكن لو انقرض العرب والمسلمون منذ عام أو منذ ألف عام، لأمكن للدارسين والأنثروبولوجيين أن يدرسوا ثقافتهم بالمعاني المشار إليها. ما الذي يميزنا عن شعب منقرض على صعيد الثقافة؟ قبل كل شيء، الإبداع، أي ابتكار معان وأفكار وقيم وتنظيمات جديدة، بما في ذلك تجديد فهمنا للموروث الثقافي ذاته. كان امرؤ القيس والمتنبي شاعران عظيمان، لكن من يكتب بطريقتهما اليوم يضمن لنفسه فشلاً عظيماً. كان ابن خلدون مؤرخاً وعالم اجتماع عظيماً، لكنه لم يعد كافياً لفهم واقعنا المعاصر. لا يستطيع أحد منا أن يكون شاعراً اليوم دون أن "يقتل" أبينا المتنبي، وأبينا احمد شوقي، بل وأبينا بدر شاكر السياب. المبدع من الشعراء (والمفكرين والفلاسفة والروائيين والمسرحيين ..) هو الذي يقتل آباءه. لذلك تاريخ الإبداع هو تاريخ الآباء القتلى أو هو مذبحة للآباء. أم الشاعر الوفي لآبائه فيجازف بأن يبقى قزماً. الوفاء ليس فضيلة ثقافية، وإن يكمن فضيلة عظيمة في علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا، حتى لو صدف ان كنا شعراء. كذلك لا يمكن ان يصنع أحدنا سينما جيدة مع البقاء ضمن سياج ثقافتنا الموروثة، ولا يمكن أن يتجدد فهمنا للدين دون اخذ مسافة من التأويلات الشائعة النصوص التأسيسية. ولا إبداع فكرياً وثقافياً دون الخروج على ولي الأمر البعثي والشيوعي .. وقطعاً الإسلامي. ولن يفعل الإسلامي غير تكرار سيرة البعثي إن ظن أن الخروج الفكري على "الأب" البعثي مباح لكنه محرم على الأب الإسلامي، وأن تحطيم السياج جميل حين يكون سياج الشيوعيين لكنه فوضى وسفاهة حين يكون سياج الإسلاميين. هل قتل الأب وتحطيم السياج والخروج على النص والأصل والوصاية ومخالفة الأمر وولاته "محض تمرد وفوضى وهياج وثورة عمياء مطلقة"، كما يقول الأستاذ احمد؟ بل هو حرية إبداع وتجديد للحياة، بما فيها الإيمان. لكن بالفعل ثمة عنصر تخريب وعصيان وفوضى في كل إبداع. فالإبداع ابن الحرية الأصغر، أما ابنها الأكبر فهو الموت. الحرية لا تبدع إلا إن قتلت، ولا تجدد الحياة دون موت. ولست أدري من أين توصل الأستاذ احمد إلى أني لا أرى للأخلاق أثراً على الثقافة؟ لعله اعتقد أني أدعو الناس إلى قتل آبائهم الذين أنجبوهم وربوهم؟ كلا يا سيدي. فوالدي، أطال الله في عمره، حي يرزق، لم أقتله ولا أفكر في قتله، كذلك لم أحطم سياج بيته. ورغم أني سجنت شيوعياً، ووالدي مؤمن حاج لا يفوت فرضاً، فإني لم أشعر يوماً أني ارتكبت مخالفة أخلاقية، أو أن أفكاري السياسية تنتهك التزامي البر به. ولعله أضحى من النافل القول إني أعتبر التحصين الثقافي حاملاً لخطر الاستبداد وفرض العقائد بالإكراه، وتكوّن طبقة من المفوضين العقيديين الذين يفتشون ضمائر الناس ويمتحنون إيمانهم. الإسلام لم يعرف ما يشبه القوميسارين السوفيات ومحاكم التفتيش في أوربا المسيحية في العصور الوسطى، لكنه عرف ظاهرة الشرطة الدينية أو المطوعة في السعودية، وعرف تعصباً دينياً فتاكاً في أفغانستان الطالبانية، وعرف في تاريخه القديم صراعاً سياسياً دينياً واستبداداً سياسياً دينياً، يصمد للمقارنة مع أي استبداد سياسي ديني في أي مكان من العالم. وأصارح الصديقين أني أعتبر عبارة الغزو الثقافي خطيرة كتشخيص وأخطر كتوصية ضمنية بالعلاج، وبالخصوص لأنها تنقل مفهوم الغزو من قاموس الحرب إلى قاموس الثقافة، مع ما يستدعيه ذلك من اعتبار بعض الأفكار والتنظيمات عدوة على غرار ما يكون الأمريكيون أو الإسرائيليون أعداء مثلاً. يمكن بالطبع لأي كان أي يصوغ آراء من يعتبره خصمه في صورة كاريكاتيرية ليسهل عليه دحضها وإظهار بطلانها، على غرار ما يفعل الأستاذ أحمد حين ينسب إلي أني أعتبر العولمة "تلاقح ثقافي وإبداع وتنوير، حتى لو كان أدب بورنو وصهينة وتجديف بكل ثوابت الأمة". هذا أسلوب المساجلين الإيديولوجيين وليس النقد الموضوعي. ومن جهة أخرى، هذا الكلام مهين للأمة التي ينبري الأستاذ أحمد للدفاع عنها. فالأمة تبدو هنا مثل "أمَة" غريرة يسهل على أي كان إغواءها و"تطبيقها" و"إخراجها عن ثوابتها". لكن لعلنا نعلم أن أغر الفتيات هن المعزولات عن العالم والممنوعات من الاختلاط والتعرض لـ "العدوى". من جهتي أعتقد أن حصانة أمتنا، سورية أم عربية أم إسلامية، في عقلها وفي حريتها وفي إبداعها، وأن المزيد من الحرية يعني المزيد من الإبداع، يعني المزيد من الحصانة (رغم أني لا أحب كلمة الحصانة في مجال الثقافة)، وأن العدوى الثقافية أمر مرغوب فيه، وأن العفة في الثقافة أمر خطير ومنذر بالعقم، وأن أكثر الثقافات عفة هي أكثرها انعزالاً وبدائية (قد تكون كوريا الشمالية عفيفة ثقافياً أكثر من أية دولة عربية، ولعل طموح كمبوديا بول بوت وأفغانستان طالبان كان عفافاً ثقافياً مطلقاً)، وأن البورنو لا يستعمر إلا شخصاً مكبوتاً تستعمره أصلاً الأخيلة الجنسية. ثم لست أدري كيف تحصننا سياسة الأستاذ أحمد الثقافية ضد البورنو اليوم؟ فبفضل الإنترنت والبث الفضائي يمكن لأي مراهق ومراهقة (وكهل وكهلة، وشيخ وشيخة) أن يشبعا حواسهما من الثمار المحرمة لجنة الجنس الافتراضية. إن شرف الأمة مثل شرف الفتاة مثل شرف الفتى: في عقلها أو عقله الناقد، وفي إرادتها أو إرادته الحرة، وفي النصف الأعلى من جسمها أو جسمه. هذا لا يعني أن نترك النصف الأسفل من أجسامنا للغرائز وحدها. ما يعنيه، أن من لا يقيم شرفه أو شرفها في رأسه وفي قلبه لا يفيده كل عفاف الدنيا. إن امرأة تافهة لا يمكن أن تكون شريفة حتى لو كان لها خمس بكارات. أما الصهينة، فليت الأستاذ أحمد يترك أمر الاختصاص في فضح "عدواها" للسيد علي عقلة عرسان واتحاد كتابه، وليته يقارن بين "حصانة" الكتاب البعثيين و"عدوى" أمثالنا. ولن أزيد. نقطتان تكميليتان: اشترك الأستاذان أحمد ووليد في نقد اتهامي المفترض للإسلاميين بالظلامية والعدمية. لكن يبدو لي أن نقدهما يفتقر إلى شيء من التبين، إذ لم يرد في مقالي قط وصف مرسل للإسلاميين عامة أو الإخوان السوريين بأنهم ظلاميون وعدميون. لقد وصفت ما سميته الاكتفائية الإسلامية، بالظلامية والعدمية ومعاداة الحضارة. ولا أجد اليوم ما يدفعني لسحب هذا التقييم. أعني بالاكتفائية الإسلامية الموقف الذي يعتبر أننا مستغنون بالإسلام عن كل فكر وثقافة وعلم آخر. وهو موقف غير نادر الشيوع في أوساط الإسلاميين، والأصل فيه هو النزعة العقيدية التي تعتبر أن كل ما هو أساسي موجود هنا، في عقيدتنا. لذلك ثمة تناسب بين الظلامية وبين النزعة العقيدية المطلقة، لذلك الإسلاميون الأكثر ظلامية هم الأكثر سلفية، وبالخصوص الوهابيون؛ ولذلك أيضاً ثمة ظلاميات ماركسية وبعثية وناصرية: تلك المواقف التي تعتقد أن كل ما هو أساسي من أجل فهم العالم وسياسة العالم وتذوق العالم والسلوك في العالم موجود في الماركسية أو البعثية أو الناصرية؛ ولذلك تجنح هذه العقائد إلى توليد نوع من العدمية، يمكن تسميته عدمية فيض المعنى أو عدمية اليقين بأن الحق معك، وأن كل من يختلف عنك على باطل، ما يقوض الحواجز الأخلاقية أمام إبادته. هنا أصل الإرهاب، إرهاب المنظمات أم إرهاب الدول. ولعل الأخوين أحمد ووليد يعلمان أن النظام البعثي لم يتمكن من تشريع إبادة الإسلاميين منذ أواخر السبعينات إلا بعد أن "شيطنهم"، أي أبادهم معنوياً كشرط لإبادتهم سياسياً وجسدياً. في المقابل، لعلهما يعلمان أن الإسلاميين مارسوا الشيء نفسه في تلك الفترة، وإن اختلفت سند "الشيطنة". سند الشيطنة البعثية "قومي" و"تقدمي" وسند الشيطنة الإسلامية ديني. ثمة نقطة أخيرة أثارت استياء ناقديّ. قلت في مقالي مثار الجدل: "لعل الإنسان حر لأنه قادر على رفض التكليف الإلهي". لست أعتز بالإثم، لكني أعتقد بالفعل أن معيار الحرية هو التمرد على التكليف الإلهي. فمن يتمرد على خالقه قادر على التمرد على كل سلطة وتجاوز كل حد واختراق كل سياج، إن للخير أو للشر. هنا أصل الحرية وأصل الثقافة، لكن أيضاً أصل الانتهاك والتحطيم. هذا خلافاً لما يبدو أن الأخوين فهماه، ليس دعوة إلى الإلحاد أو رفض "التجارة" الإلهية المنجية، ليس دعوة أصلاً، إنه استدلال على أننا أحرار، وعلى أن الميثاق الإلهي هو بالأصل ميثاق حرية. إذا كنت أستطيع أن أقول لله: "لا"، فهل يستطيع أن يستعبدني طاغية أو سفاح؟ هذا تعريفي كإنسان. ولعل "لا" هذه، المؤسسة للحرية، هي الأمانة التي عرضت على "السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوماً جهولاً". ظالم لنفسه، جاهل لعبء تنوء به الجبال، بل والأرض والسماء. يا له من غرور! ويا لها من حرية! لدى الإسلاميين استدلال آخر، معكوس، وخاطئ، في رأيي: العبودية لله تحرر من كل عبودية، أي تحرر من كل ما دون الله. خاطئ، لأنهم يقيمون كمال الخالق على نقص جذري للمخلوق، وإطلاقية الخالق على محدودية مطلقة للمخلوق. أما التمرد على التكليف، فهو ارتفاع بالخالق وارتفاع بالمخلوق. فما دام من يخلق الحر أعظم ممن يخلق العبد، وما دام الخالق هو الأعظم بالتعريف، فإن حريتنا هي الإقرار الحق بعظمة الخالق وهي "تسبيح" له. __________ * كاتب سوري - دمشق
أبو مـــــــــ1984ـــــــارال
خبز,, سلم,, حرّية
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
|
||||||

|
|
|
#2 | ||||||
|
مشرف متقاعد
|
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
لذلك فأنا آخذ منه الخطوط العريضة .. وأسقطها على واقعي .. بمفهومي وليس بمفهومه .. وأنا برأيي الشخصي أن الوصول الى الابداع في أي مجال يتطلب اباحية (واعية ) في كل شيء .. لأن أي قيد يمكن أن يوقف الابداع (وأنا لا أعني بالقيود الأعرف الأخلاقية أو الانسانية) بل القيود الصنمية التي نعيشها .. اقتباس:
اقتباس:
للأسف .. أبو مارل بالنهاية مشكور كتير على هالمقال الموسوعة والغني بأشياء رائعة .. وكل ما وقع بين أيديك هيك مقال تبقى نزلو أو ابعتلي أياه .. أحلى أبو مارل
..غنــــي قلــــــيلا يـــا عصـــافير فأنــي... كلمـــا فكــــرت في أمــــــر بكـــيت ..
|
||||||

|
|
|
#3 | |||||||
|
مشرف متقاعد
|
اقتباس:
و أصلاً ما بموت الدين غير الدولة الدينية و مو بس مثال إيران يلي ما عندي شي دقيق تجاهه، و إنما عنا أمثلة أشد سفوراً متل السعودية و نظام طالبان، إي يعني الأفغان كرهو الإسلام من ورا طالبان
لطالما قلت أن الإنسان هو إنسان ما لم يتخلى عن كونه إنسان
لكني الآن أقول أن الإنسان يبقى إنسان حتى لو تخلى عن كونه إنسان، إذا بقي على وجه الأرض إنسان لم يتخلى عن كونه إنسان |
|||||||

|
|
|
#4 | |
|
مشرف متقاعد
|
اقتباس:
|
|

|
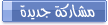
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
|
|
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 15:39 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)







