
|
| س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | مواضيع اليوم | بحبشة و نكوشة |
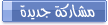
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو
-- زعيـــــــم --
|
برهان غليون
عندما ورث بشار الأسد السلطة عن أبيه كنت أعتقد اعتقادا راسخاً، وهو ما كررته مرارا في مقابلاتي ومقالاتي، بأن الخيار الوحيد الناجع للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وتجنب المواجهات الداخلية والخارجية التي تهدد استقلالها وتسيء إلى موقفها الاستراتيجي تجاه إسرائيل وتضمن في المقابل مكانتها ومصالحها الوطنية على الصعيد الدولي والإقليمي، هو العمل السريع على خطين متوازيين. الأول، تحقيق الانسحاب السريع لسوريا من المعارك الخارجية التي ارتبطت باستراتيجيا مواجهة دولية وإقليمية انتهى عصرها، ووصلت إلى طريق مسدود، وفي مقدمة ذلك، الانسحاب الطوعي من لبنان والكف عن الضغط على السلطة الفلسطينية والتلاعب ببعض القوى المتطرفة الإسلامية وغير الإسلامية، لأغراض السياسة الخارجية والتركيز، بالعكس من ذلك كله، على إعادة بناء العلاقات السورية الإقليمية على أسس جديدة ايجابية قائمة على قاعدة توازن المصالح والندية والاحترام المتبادل. وكان اتفاق أضنة الذي وقّعته دمشق مع تركيا في نهاية التسعينات، يشكل في نظري برهانا قاطعا على ما يمكن لسوريا أن تقطفه من عوائد نتيجة تغيير أسلوبها السياسي، مع العلم أنها لم تقبل بتغيير سياستها في هذه الحال إلا تحت الضغط والتهديد العلني بالحرب والاجتياح. والثاني، خط التفكيك المنظم والطوعي لنظام الحزب الواحد والحكم المطلق، الذي تحول في سوريا إلى قدر لا راد له، بينما صار استمراره مصدر مهانة يومية لشعب كامل، وفتح الحقل السياسي في سبيل إعادة بناء علاقات السلطة مع الشعب وملء الفراغ السياسي والفكري والأخلاقي الهائل، الذي تركته عقود طويلة من السيطرة الآلية، إن لم نقل الوحشية على المجتمع، وحلت فيه جميع العرى المادية والمعنوية. وكانت مراهنتي في ذلك، على ما قيل في ذلك الوقت، عن الانفتاح الذي وصف به فكر الرئيس الجديد، وبشكل خاص، على ما يتمتع به، وهو ابن الرئيس حافظ الأسد، من أهلية لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، لتغيير السياسات السابقة وتجاوز إرث والده السياسي، من دون أن يجرؤ أحد على اتهامه بالخروج على الخط أو بالعداء لأفكار الحقبة السابقة وقيمها. بل لقد قلت بأن انخراطه الجدي في هذا التغيير هو وحده ما كان سيضفي على عملية توريث السلطة نوعا من الشرعية. بيد أن ما حصل كان معاكسا تماما لما كان منتظرا لسوء الحظ. فبدل إسراع العهد الجديد بمراجعة استراتيجيا سوريا الوطنية والإقليمية والدولية، وإعادة صوغ خياراتها وأهدافها في اتجاه مزيد من التحرر من أعبائها الخارجية ومتعلقات المعارك والحروب السابقة السلبية. في اتجاه التركيز على إعادة بناء الداخل وتعزيزه، تبنت السلطة الخيار المباين تماماً. واعتقدت أن أفضل وسيلة لقطع الطريق على الأخطار المنظورة وغير المنظورة المقبلة، هي التكور على النفس والعمل على تجديد شباب أسس السيطرة الشاملة الداخلية والإقليمية، أي العودة إلى سياسات التحكم الأمني الدقيق بحركة الأحداث اليومية داخل سوريا، والتثبت على سياسة تعزيز المواقع السورية الخارجية بالمزيد من القوة والإكراه. وهذا ما حوّلها بسرعة، من العراق إلى فلسطين ثم إلى لبنان، إلى فخ وقع فيه النظام السوري بكامل عدته. فأصبح ينتظر قرار الدول الأجنبية بشأنه، بعدما كان يقرر أو يعتقد أن في إمكانه أن يقرر، في مصير المجتمعات والقوى ومناطق النفوذ الإقليمية. لا أعتقد أن هناك مخرجا للنظام من الشرك الذي وضع نفسه فيه. ولن تتركه القوى الدولية منذ الآن يسترجع أنفاسه لحظة واحدة. لكنها سوف تستمر في تكثيف الضغوط المتنوعة، العسكرية والسياسية والاقتصادية والقانونية والإعلامية المتواصلة عليه، في انتظار أن يتصدع من تلقاء نفسه وينهار. ولن تفيد أعمال التفجير التي تتكرر في لبنان، كائنا من كان المسؤول عنها، إلا في تقديم ذرائع إضافية للقوى الدولية، حتى تطور موجة العداء والمقاومة وتضييق الخناق على النظام الأمني السوري - اللبناني. إنها تعلن نهاية معركة، أكثر مما تعكس إرادة قوة متجددة، أو تعبّر عن إرهاصات حرب جديدة. لا أعتقد كذلك أن في إمكان النظام، مهما ارتفعت النداءات والمطالبات والاستغاثات الداخلية، القيام بأي إصلاح يجنّبه المصير المحتوم أو يضمن إنقاذه. ولا يمكن عمل شيء سوى تفكيكه بشكل طوعي، لإقامة نظام آخر في مكانه يضمن لبعض عناصره البقاء والاندراج في مسار سياسي جديد، أو انتظار انهياره وتفكيكه على أيدي قوى أخرى داخلية أو خارجية ولصالحها. وأعني بالنظام، أسلوب الحكم الراهن والتوازنات التي يستند إليها والقوى التي يخدمها والغايات التي يسعى إليها معا. وليست الأخطاء الاستراتيجية والسياسية القاتلة التي ارتكبها في السنوات الماضية إلا التعبير عن الطريق المسدود الذي يجد نفسه فيه، وما كان من الممكن أن لا يرتكبها، مهما حصل عليه من إرشادات وما أسدي له من نصائح في الداخل والخارج. فهو مدان بسبب وضعه وخياراته الأساسية بخوض حروب خاسرة وبارتكاب أخطاء فوق أخطاء. ليس هذا مطمئنا في أي حال. فالأخطار كبيرة بالفعل وعديدة. ولن يكون الانتقال نحو نظام ديمقراطي، لا في سوريا ولا في لبنان مفروشا بالورود. والسؤال: هل يمكن للقوى المحلية أن تكون شريكا في الانتصار؟ أم أن سقوط النظام سوف يكرس أيضا، وهذا ليس بمستبعد، فراغ القوة المحلية التي خلقها هو نفسه من حوله، وتالياً الهيمنة الخارجية المباشرة أو غير المباشرة، عن طريق القوى المرتبطة بها، عسكرية أكانت أم مدنية؟ في نظري أن كل الاحتمالات مفتوحة. وليس هناك طريق آخر، لتفكيك النظام بأقل خسائر ممكنة، سوى السعي بجميع الوسائل لإيجاد حلفاء للقوى الديمقراطية من داخل النظام. وهم موجودون بالفعل, لكن ما يمنعهم من التعبير عن أنفسهم هو الخوف المتأصل فيهم والرعب الذي لا يزال النظام قادرا على بثه في قلوبهم وقلوب القطاعات الواسعة من الرأي العام. ومن المتوقع أن يزول هذا الرعب تدريجا مع الزلزال الذي ضرب مفهوم السلطة الأمنية ونمط السيطرة الذي فرضته في لبنان بصورة مروعة، وما أدى إليه ذلك من انكشاف النظام وتزايد عدد القوى الداخلية والإقليمية التي كانت مضطرة للخضوع له وعزمها على إظهار مناهضتها لسياساته، وسعيها للتفاهم من حوله. لكن قبل ذلك وشرط ذلك أيضا، أن تخرج القوى الديمقراطية السورية نفسها من قمقمها، وأن تظهر ثقة أكبر بنفسها، وتتجاوز حال الشك والتردد والاتكال والعجز التي تكبلها، حتى تستطيع أن تفرض حضورها بقوة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وتضمن المشاركة في معركة تقرير مصير مجتمعها. في الوقت الراهن، لا يستطيع أحد أن يحسم في الأسلوب الذي سيتم به تفكيك النظام أو انهياره، بأي وسائل وعلى أيدي مَن ولصالح مَن. فليس هناك من يستطيع أن يقرر بالضبط أو يتنبأ بقرار اللاعبين العديدين المعلنين والمحتملين، الذين سيثير شهيتهم ضعف النظام وتفكك أوصاله بما في ذلك قوى موجودة داخل النظام. وإذا أصر الأميركيون، كما هو واضح اليوم، على تكبيله بالعقوبات والحملات الإعلامية والسياسية، وإنهائه لصالحهم، فليس لدى أي قوى أخرى داخلية أو خارجية، وفي مقدمة ذلك المعارضة السورية، القدرة على الحيلولة دون ذلك. إنما تستطيع المعارضة الديمقراطية، ومن واجبها، أن لا تشارك في هذه الوليمة، ولا أن تغطي عليها. أعني أن تظل ملتزمة الخيار الديمقراطي والدفاع عن السيادة الشعبية في مواجهة أي سلطة قد يفرزها التحلل الحتمي للنظام. وبالمثل، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحصل في المستقبل. هل ستعرف سوريا وضعا شبيها بما حصل في العراق أو كما حصل في لبنان؟ فالأمر يتوقف على عوامل عديدة في مقدمها حركة الرأي العام السوري الذي لا يمكن لأحد توقع رد فعله على الأحداث المقبلة، وعلى طبيعة هذه الأحداث التي ستحسم في أمر النظام. كما لا نعرف بعد بالضبط ماذا سيكون عليه التوافق الأميركي - الأوروبي في شأن المصير السوري. وهل يضطر الاوروبيون تحت تأثير السياسات السورية إلى الاصطفاف وراء الخيار الأميركي الهجومي؟ هذه أمور لم تحسم بعد. إن ما حسم، هو وقف التعامل الدولي مع النظام. ومن المحتمل أن تتجه السياسات الدولية بشكل أكبر في القريب، نحو عزل النظام واعتباره نظاما شاذا خارجا على المألوف، وربما على القانون. وعلى الأغلب سيكون المخرج السوري بعيدا عن المثالين العراقي واللبناني معا، أي تصدعا للنظام، يفرز قوى انقلابية ذاتية، تواكبها تحركات شعبية قوية، تفتح طريق التغيير بإنهاء حكم حزب البعث الاسمي، وتعترف بالتعددية السياسية قبل أن تسعى إلى إعادة السيطرة هي نفسها على الوضع. أما في ما يتصل بطبيعة العلاقات التي ستنشأ أو يمكن أن تنشأ بين سوريا ولبنان في المستقبل، فالأمر مرهون بطبيعة النظم التي ستستقر فيهما. ولن تقوم علاقات ثابتة ومستقرة وايجابية تساهم في تصفية ذيول الحقبة القاسية السابقة، وبناء علاقات مثمرة تخدم مصالح الشعبين، إلا مع ترسخ نظم ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعبين وتضمن الوسائل المؤسسية السليمة لتضامنهما وتعاونهما. وهذا يتطلب أيضا من الديمقراطيين اللبنانيين والسوريين العمل على نشر ثقافة ديمقراطية فعلاً، تستبعد العنصرية والتكبيل بالتهم التاريخية، كما تستبعد النزعات الوطنية الشوفيينية المضرة بأصحابها قبل أعدائها. لكن حتى نصل إلى هذا الطور علينا خوض معارك طويلة وصعبة في سوريا ولبنان معا، ليس في مواجهة نظم الاستبداد والأمن ومساوئها فحسب، ولكن أكثر من ذلك ضد الجهل والتحيز والتعصب والخوف والتشوه في الوعي عند الرأي العام والفرد الذي تعلّم رفض المسؤولية والاستقالة الأخلاقية والسياسية واستمرأ الأنانية والتعلق الدنيء بالمصالح الفردية والعائلية، على حساب الجماعة الوطنية في سوريا ولبنان معا. وهي معركة قاسية وطويلة، معركة الثقافة والسياسة العربيتين في الوقت نفسه. وفي النتيجة، إن كل الظروف تجتمع كي لا يكون في إمكان المثقفين ولا القوى الديمقراطية تغيير النظام أو وراثته. ولقد فعل أصحابه كل ما أمكنهم فعله كي يوصلوا البلاد إلى معادلة الاختيار المستحيل: بين الطغيان والتحالف مع الاستعمار، اعتقادا بأن الجمهور الواسع سيختارهم في النهاية. والحال إن عكس ذلك هو ما سوف يحصل. لا يمكن للمثقفين الديمقراطيين القبول بأي من الخيارين كما لا يمكنهم الوقوف متفرجين على ما يحصل لمجتمعهم وشعبهم. إن التسارع الكبير في الأحداث يستدعي منهم الانخراط بقوة في معركة التغيير، والسعي للعب دور توجيهي فيه يحد من تأثير القوى الاستعمارية والانتهازية والوصولية التي ستركب الموجة لا محالة، ويدفع في اتجاه تقدم حظوظ الخيار الديمقراطي البديل. وهو ما يتطلب العمل الجماعي الشاق على طريق إعادة بناء المجتمع، أي الثقافة والقوة المنظمة، التي لا تجعل من الخيار الديمقراطي الوطني خيارا ممكنا فحسب، ولكن راهنا أيضا. أما التحالف مع الطغيان أو الاستعمار، فلن يقطع الطريق على هذا الخيار الديمقراطي فحسب، لكنه سوف يلغيه أيضا. ذلك أن بناءه من حيث هو خيار شعبي ووطني لا يتحقق، في سوريا والعالم العربي المهدد بالسيطرة الأجنبية، إلا في الصراع المرير ضد هذا التوأم البغيض والمتضامن معا، أعني توأم الطغيان والاستعمار، وانتصاره لا يتم إلا بهزيمتهما. ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ من مواد جريدة الرأي العدد 41
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΞΙΡΟ
|

|
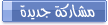
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 17:17 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)





