
|
| س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | مواضيع اليوم | بحبشة و نكوشة |
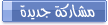
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
من أوائل الأعمال الأدبية التي نشرت للأستاذ، وهي «أقصوصة مصرية» كما سماها تحمل عنوانه «حكمة الموت»، وقد نشرت في مجلة «الرواية» في عددها في 15 أغسطس عام 1938، ثم طواها النسيان إلي أن بعث إلينا بها المهندس محمود الكردي ابن شقيقة الأديب الراحل.
حكمة الموت أقصوصة مصرية بقلم: الأديب نجيب محفوظ مضي شهر تقريبًا وحضرة محمد أفندي عبد القوي يشعر بتوعك المزاج. آيته همود في الجسم وثقل في الدماغ ووهن ـ يشتد حينًا ويخف أحيانًا ـ في الساقين، وقد سكت عن حالته الطارئة طوال الشهر وهو يعللها بكثرة العمل تارة وبإدمان السهر تارة أخري، وفعلاً طلب إجازة قصيرة وكف عن السهر راجيًا أن تعود صحته إلي حالتها الطبيعية.. وانتظر علي هذا الرجاء أيامًا وما تزداد حالته إلا سوءًا حتي لم ير بدًا من استشارة طبيبب. وقال له الطبيب ـ بعد أن فحصه بدقة وعناية ـ إنه مصاب بضغط الدم وأشار عليه بالتزام الراحة أيامًا وبالاقتصار علي الطعام المسلوق والفواكه، والامتناع عن تناول اللحوم الحمراء وتعاطي الخمور ثم وصف له الدواء اللازم. ورجع محمد أفندي من عيادة الطبيب خائفًا مذعورًا كثير الهم والفكر.. وقد يكون هذا ـ في ظاهره علي الأقل ـ غريبًا لأن الضغط لم يكن شديدًا، ولأنه من الأمراض التي يمكن تلافي خطرها بالعناية والحرص في اختيار الطعام والطعام والشراب، ولأن محمد أفندي شاب في الخامسة والثلاثين فلا ينذره الضغط بما ينذر به ذوي الستين أو السبعين. والأعجب من هذا كله أنه لم يكن غافلاً عن هذه الحقائق ولكنه في الواقع لم يخش المرض في ذاته قدر ما خشي التاريخ أعني تاريخ أسرته. فهو يذكر أن أباه أصيب بالضغط وهو في مثل عمره تقريبًا ويذكر أنه لم يقاومه طويلاً فساءت حالته وأصابه الشلل فقضي في عنفوان شبابه وقوته. ولم يكن موت أبيه في عنفوان شبابه حادثًا غريبًا في أسرته، فهكذا قضي جده من قبل ولم يجاوز الأربعين.. إن ذاكرته لا تحفظ له من حياة والده إلا آثارًا خفيفة لأنه توفي وهو ـ أي محمد ـ غلام صغير، ولكن صورة المرحوم المعلقة بحجرة الاستقبال أثر باق يشهد بالشبه العظيم بين الابن وأبيه، وإن الناظر إلي الصورة ليقتنع بهذه الحقيقة التي تدل علي أثر الوراثة.. فالجبهة المربعة والعينان العسليتان المستديرتان، والأنف الكبير المائل إلي الفطس، والفم العريض المغطي بالشارب الغليظ، والوجه الممتلئ والجسم البدين.. جميع هذه معالم مكررة بين صورة الراحل والشخص الحي كالأصل وصورته، وكأن صاحب الصورة هو محمد نفسه في ثياب بلدية.. الجبة والقفطان والعمامة.. يا له من شبه عجيب! ولم يكن غافلاً عنه ولكن خيل إليه عندئذ أنه يفطن إليه لأول مرة في حياته أو أنه اكتشف فيه مغزي كان عنه خافيًا.. ولا مراء في أن الشبه بينهما لم يقف عند حد الشكل فطالما سمع والدته تنوه بأوجه الاتفاق بينه وبين أبيه في الخلق والطبع في المناسبات المختلفة. فكان إذا احتد وغضب لأتفه الأسباب تنهدت وقالت: «رحم الله أباك.. ليته أورثك غير هذا الطبع طبعًا هادئًا».. أو إذا جلس إلي الحاكي ينصت في انتباه ويهز رأسه في طرب قالت وهي تبتسم له: «ابن حلال يا
شُذَّ، شُذَّ بكل قواك عن القاعدة
لا تضع نجمتين على لفظة واحدة وضع الهامشيّ إلى جانب الجوهريّ لتكتمل النشوة الصاعدة |

|
|
|
#2 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
بني..» أو إذا رجع إلي البيت بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل ثملاً مترنحًا استقبلته قلقة حزينة وتصيح به وهي تغالب دموعها «إن جرح قلبي لم يندمل.. فلا تفجعني فيك كما فجعت في والدك من قبل..».
فهو صورة صادقة لوالده في شكله وخلقه وطبعه وها هو ذا يرث عنه مرضه.. فلم لا تكون نهايته كنهايته؟ واأسفاه! إن هذه الأسرة مقضي عليها بالدمار فقد قضي جده شابًا، وقضي مثله والده، فليس إذًا هذا المرض من المصادفات المحزنة.. ولكنه بداية النهاية، وما هو إلا معيد تمثيل الدور القصير الذي قام به من قبل المرحوم والده، وقام به قبله جده، وما مرضه هذا إلا سبب تعتل به الطبيعة عليه لتنفذ قضاءها المحتوم من شجرة أسرته البائسة المقضي عليها بالذبول والجفاف في إبان ربيعها. وجعل يردد فيما بينه وبين نفسه: «الشكل واحد والخلق واحد والسيرة واحدة والمرض واحد فالنهاية واحدة دون ريب»، وتشبث وجدانه بهذه الأفكار فقويت عقيدة الموت في نفسه وملأت شعوره فتمثلت له حقيقة لا تتزحزح، واستسلم لها استسلامًا تامًا حتي أشفي علي القنوط، وبات ينتظر القضاء المحتوم الذي يراه قريبًا.. بل أدني إليه من مخاوفه. إننا جميعًا نعلم أننا سائرون إلي الموت ولكنا لا نذكر هذه الحقيقة إلا حين حوادث الوفاة أو لدي زيارة المقابر وفي الساعات النادرة التي نستسلم فيها للتأمل.. وفيما عدا ذلك فجلبة الحياة تغمر عادة سكون الموت، وحرارة الأمل تقصي عن أفكارنا برودة الفناء. أما الآن وقد ضرب له شعوره ومنطقه موعدًا قريبًا للموت فقد ولي وجهه هذا الأفق القريب لا يحول عنه، وجعل يديم إليه النظر في استسلام وحزن ويأس. وعجب في أحزانه لمن يقول إن الموت راحة، ولم يفقه لها من معني إلا أن تكون تململاً وضيقًا بمتاعب الحياة، ولكن ما هذه المتاعب بجانب ظلمة الموت ووحشة القبر؟ الموت ياله من حقيقة مخيفة.. لم يشعر بهولها من قبل.. تري ما هو هذا اللغز الغامض؟ وما كنهه؟ وما حقيقة الروح التي ستفارقه بعد زمن يسير وتصعد إلي بارئها؟ وذكر عند ذاك الآية الكريمة «يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» أما هو فلم يأت من العلم كثيرًا ولا قليلاً، وحسبه أن يعلم أن الروح ـ وهي منبع حياته ووجدانه وأفكاره ـ ستهجر جسده البائس آخذة معها كل جميل حي غير تاركة خلفها إلا أثرًا جامدًا.. أو جثة كما يقولون.. فواأسفاه! ودلف إلي المرآة وألقي علي وجهه نظرة ملؤها الأسف والحزن.. وتأمل صورته طويلاً، وجعل يقبض كفيه ويبسطهما.. كم هو ممتلئ صحة وعافية وشبابًا! سينضب معين هذا كله.. ويجف غصنه الرطيب.. وتغيض معاني اليقظة في عينيه.. ويمسي جثة.. ممزقة.. نتنة.. قذرة.. ترعاها الديدان.. ما أفظع هذا! والأدهي من ذلك أنه لم يشبع من الدنيا وأحس في تلك اللحظة كأنه لم يبدأ رحلة حياته بعد، وود من أعماقه لو تتاح له فرصة فيعيد الكرة، ليعيش حياة الطفولة السعيدة مرة أخري ويعيد عهد الصبا وينقلب إلي الشباب عمرًا مديدًا، ولا يترك الدنيا إلا وقد شبع من مسراتها وتزود من خيراتها. كلا إنه لم يشبع من الدنيا ولم يتمتع بحياته كما ينبغي له.. وإنه ليسأل نفسه وسط حزنه وأسفه وبأسه: «ماذا صنعت بحياتي؟» فيعييه الجواب كأنه ولد بالأمس القريب، ثم يزول عنه الإعياء والعجز فتأتيه الذكريات |

|
|
|
#3 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
تباعًا، خفافًا وثقالاً، فلا يكاد يظفر فيها بما يجوز أن يعده من السعادة الصافية التي تطيب بها الدنيا وترجي لها الآخرة.. أما ما ينغص الطمأنينة وينتزع آهات الحسرة والأسف فكثير لا يحصي، وما يتبقي من الوقت ما يتيح الفرصة لإصلاح فاسده والتكفير عن سيئه..
ماذا صنعت بحياتي؟ قد يطرح هذا السؤال قوم فيأتيهم الجواب السعيد في آيات الفكر التي أورثوها الإنسانية كافة أو الأعمال المجيدة التي بذلوها لأوطانهم أو الكفاح النبيل الذي أدوه للأسرة والأبناء، أما هو فلم يك واحدًا من هؤلاء.. لم يضطلع بتبعة من تبعاتهم ولم يبذل تضحية من تضحياتهم ولم تكلل هامته بوسام من أوسمة مجدهم وجهادهم.. فلم يختلج في صدره قط معني من معاني الإنسانية ولم يعرف الوطنية إلا شقشقة لسان وجدل فراغ، ولم يقدم علي الزواج ولا قدر ما فيه من مغزي طبيعي خالد أو واجب اجتماعي نبيل. وبالجملة عاش لنفسه يرسف في أصفاد الأنانية وينزلق يومًا بعد يوم في مهاوي الحيوانية والجمود. وقد يكون من المغالاة أن يقال إنه لم ينتبه من قبل إلي تفاهة حياته ولكنه لم ينتبه إليها الانتباه الحري بأن يبعث فيه روح الندم الصادق وأن يحثه علي التفكير والتجديد، فكان إذا ضايقه التفكير في تفاهته أغمض العين علي القذي وقال لنفسه معزيًا: «إن في العمر متسعًا للتغيير» ولكنه لا يستطيع أن يقول ذلك الآن والموت لا يمهله إلا شهورًا معدودة.. ولو أن حياته اقتصرت علي التفاهة لربما هان الأمر.. ولكنها تتلوث في صميمها بالإثم والشر والخنوع مما يندي له الجبين خجلاً ويندي له القلب ألمًا وحزنًا.. ذكر حياته الحكومية فذكر بها الذل والهوان والضعف والجبن.. هو ولا شك موظف مجتهد ودقيق في عمله ولكنه كان دائمًا أضعف من أن يقاوم الوسط الذي وجد فيه، فكان يجاري التيار ويتفادي التصادم ويخنع إشفاقًا من النقل والاضطهاد فأدي به خوفه من الاضطهاد إلي أحط أنواع الاضطهاد والذل، ووجد نفسه يخوض في الأعراض ويجامل في الحق ويتغاضي عن الذل ويسكت عن الإهانة.. فياللضمة! وذكر حادثة أهوت به إلي الحضيض وتقبلها في وقتها قبول الفاجرين، إذ كانت تختلف إلي بيته امرأة عجوز تحتال علي العيش ببيع البيض والفاكهة، وكانت أمه تشملها بالعطف فتطعمها وتكسوها مما جعل المرأة تطمئن إليها وتعهد لها بحفظ أرباحها الضئيلة حتي تجمع لديها خمسة جنيهات أوصت ـ إذا أصابها قضاء الموت ـ أن تردها إلي ابنتها البائسة وأبنائها اليتامي.. وماتت العجوز فعهدت أمه إليه برد المال إلي مستحقيه.. واأسفاه!.. لقد كان يعلم أن المتوفاة كانت تخفي أمر تركتها عن ابنتها، فما كان منه إلا أن دس الجنيهات في جيبه وبددها في المقامرة والشراب.. وهضم ضميره البليد فعلته الشنعاء وارتضي السرقة وحرمان اليتامي حقهم دون وخز أو ألم.. فأي دناءة وحقارة! وذكر ليالي العربدة والفجور التي عرفته فيها الحانات مدمنًا لا يريم، وموائد القمار لاعبًا مدلسًا لا يشق له غبار، والمستهترات رفيقًا لا يشبع ولا يرعوي.. أواه.. إنه ينبغي له أولاً أن يستل الدين والإيمان من صدره قبل أن يعد تلك الليالي الحمراء من الحياة السعيدة التي لا يجوز أن يندم علي ما فعل فيها. وذكر أيضًا غرامه.. فقد استطاع قلبه علي تفاهته وتلوثه ـ أن يحس ويخفق، ولكنه كان غرامًا عجيبًا، بل لو أن إنسانًا سماه كراهية ما جاوز الحقيقة.. كانت فتاته أخت طبيب كان في صباه صديقه الحميم، ثم أنأته |

|
|
|
#4 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
عنه أسباب الدراسة والعمل فانتهي هو إلي وظيفته المجهولة وبدأ الشاب حياة الكفاح والنجاح، ولم تكن طبيعة محمد بمستطيعة أن تهضم هذا الفارق بينه وبين صديق الصبا دون أن تفرز الحقد والحسد، وزاد سخيمته إهمال صديقه القديم له وزهده في معاشرته، وأجج من نيران غضبه عليه ما ترامي إلي سمعه من زيغ صديقه وعدم اكتراثه للأديان وإيمانه بالعلم وحده دون غيره.. ولكن ذلك كله لم يستطع أن يمحو من صدره ولعًا تربي في قلبه منذ الصغر بإحسان شقيقة الطبيب الناكث الناجح الكافر. ما كنه هذا الولع؟
كانت الفتاة ـ إذا حرصنا علي المجاملة ـ متوسطة الجمال وربما دلت بعض قسماتها علي دمامة، ولكنها كانت ممتلئة الجسم بضته، مفصلة الثنيات خفيفة الروح، فكان يسري من مشهدها إلي صدره ما يشبه مس الكهرباء، وكان يبقي في أعصابه من أثر رؤيتها قلق وألم فاقتنع فيما بينه وبين نفسه بأن صاحبة هذا الجسم البض حرية بأن تسكن قلبه وتطفئ نيرانه. وكان المنتظر والحال هذه أن يتقدم إلي صديقه القديم طالبًا يدها، ولكنه توقع الرفض ورجحه نظرًا للفارق بينهما وبين أسرتيهما، وسلم بظنه تسليمًا دون مناقشة أو مراجعة أو اختبار، فانقلب أشد حقدًا علي صاحبه وعلي الدنيا جميعًا.. وطارد الفتاة حتي أوقعها في شباكه فكانا يختلسان اللقاء الحين بعد الحين، وكانا يذهبان إلي الحدائق يطلبان غرة من الناس وهنالك يلف ذراعه بذراعها ويروي غلته بلمسها وتقبيلها، ويعطيها في مقابل ذلك وعودًا خلابة. ثم يعود ظافرًا بإشباع عاطفته والانتقام من كبرياء صديقه القديم. يا لها من نذالة!.... إنه يعبث بفتاة تصدقه الحب وتخلص له أيما إخلاص.. فلو أن نيته صدقت علي الزواج منها لربما فاز ببغيته، ولربما كان هذا الزواج خير علاج لحياته البائسة. ومن يعلم فلعله كان الآن أبًا يتعزي بما يخلف في الدنيا من أبناء يمدون خيط حياته القصير ويعيدون حياته الفانية. ومهما يكن من أمر فما عساه صائعا ولم يبق له من العمر إلا أيام أو شهور؟ ماذا هو فاعل بشهوره الباقية؟ هل يركن إلي الراحة والدعة؟ أم هل يطبع علي عينيه فيستهتر ويتمادي في غيه؟ أم هل يستطيع أن يصلح في شهور ما أفسده في خمسة وثلاثين عامًا؟ ليس الإنسان حرا في الاختيار كما يتراءي له، وقد كان محمد ـ علي تفاهة حياته وقذارتها ـ يؤمن بالله وباليوم الآخر فبث إيمانه الخوف في نفسه وجعله يشفق من عاقبة الموت فاختار سبيل الإصلاح. نعم قد لا يستطيع أن يصنع شيئًا ذا بال، ولكنه علي كل حال لن يعدم طعم الراحة التي يثيب عليها الاجتهاد. إن الموت قريب وهو يحس بدنوه منه ساعة بعد ساعة، ولكن رسوخ هذه الحقيقة في نفسه جمع شتاتها وقوي جنانها وملأه شجاعة واستهتارًا بالمخاوف، مخاوف الدنيا جميعًا، ومم يخاف بعد اليوم؟ بل كيف يخاف شيئًا؟ لقد كان حب الحياة مبعث مخاوفه جميعًا، فلما صار حبًا ضائعًا لا فائدة فيه انحلت عقدة مخاوفه وانطلق من إساره حرًا طليًقا لا ينوء صدره بشيء من تكاليف الحياة. كم كان يخاف الرجال ـ أو بعض الرجال علي الأصح ـ وكأنه يكتشف الآن فقط أنهم أناس مثله، وكم داس علي الحق والكرامة في سبيل مرضاتهم! وكم ضيع من فرص في الحياة؟! لا خوف بعد اليوم.. ولا مجاملة في الحق.. ولا فر حيث يجب الكر.. ولا إحجام حيث ينبغي الإقدام.. كلا كلا.. لقد انقلبت المخاوف جميعها |

|
|
|
#5 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
ألاعيب أطفال وسيشق طريقه في الحياة غير هياب.
واستحال محمد أفندي عبدالقوي إنسانًا غير الإنسان الذي عرفه الناس. وكان أول ما صنع أن سحب من نقوده المودعة في البريد خمسة جنيهات وذهب لتوه إلي المرأة ابنة العجوز المتوفاة وأعطاها إياها وهو يقول: «هذه أمانة أمك ترد إليك» ووقف لحظة ذاهلاً أمام الفرح الذي غمر قلب المرأة البائسة وفاض منه إلي أبنائها وشمل البيت جميعًا في ثوان سريعة، وشارك فيه وهو لا يدري وخيل إليه أنه محدثه فأحس بسعادة ظاهرة لم يخفق بمثلها قلبه من قبل. وألغي إجازته وعاد إلي وظيفته بعزم جديد، وحدث ما كان متوقعًا فوقع الصدام بينه وبين رئيسه وبين زملائه وجرت علي لسانه كلمات لم تكن لتنتظر منه أبدًا وكانت موقع الدهشة لدي الجميع، ذاد بها عن الكرامة وذم «الاغتياب» ورد بها المتحرشين وجعلته بطل ثورة غريبة حار الجميع في تعليلها، ووجد الجو من حوله يتغير سريعًا وآنس من البعض ميلاً إلي إبعاده أو تأديبه ولكن شيئًا واحدًا لم ينازعه فيه إنسان وهو الاحترام الظاهر والمعاملة اللائقة، ورضي بذلك مغتبطًا ولم يبال بما تخفي الصدور أو ما تخبئ الحنايا. تري أمن الحكمة أن يغضب القوم وهو علي أبواب الأبدية؟ ولكن ما حيلته وهم لا يرضون عن إنسان يعرف حقًا لإنسانيته وكرامته، وهو علي كل حال لا يعبأ بالناس في سبيل مرضاة الله الذي هو علي وشك المثول بين يديه... وإحسان! ماذا هو صانع بها؟ لقد ضيع الفرصة السانحة وترك شبابه يتسرب من بين يديه وهو غافل عنه بالاطمئنان إلي العمر المديد.. ومهما يكن فالأمر واضح لا لبس فيه، وليس عليه إلا أن يذهب إلي صديقه القديم ويطلب يدها فإذا رفض ـ وهو حتمًا سيرفض ـ عاد مطمئن الضمير ملقيًا عن نفسه ما ينغصها من وخز الألم والتأنيب.. ولن يضير إحسانًا اختفاؤه من حياتها لأن عدم الزواج من ميت ليس خسارة تذكر.. وذهب إلي صديقه القديم وحادثه في الأمر وانتظر الجواب الذي قدره، ولكن حدثت معجزة لم يقدرها مطلقًا.. فرحب به الشاب وقبل طلبه وشد علي يده بحرارة. يا للعجب! لقد كان أعمي حقًا، ولكن ما العمل الآن؟ فقد غدا الزواج منها جريمة لا تغتفر لأن معناه أن يغادرها بعد حين قليل أرملة في عنفوان الشباب وربما ترك في بطنها طفلاً يتيمًا.. ووجد نفسه في حيرة ظلماء لا يهتدي فيها إلي مخرج، فقد قبل طلبه بالموافقة التامة وعلمت به إحسان، ولا شك أنها تنتظر الآن بفرح عظيم الخطوات الختامية، وهو لا يستطيع أن يتقدم ولا يدري كيف يتقهقر. ولم ير بدًا في النهاية من الإفضاء إلي فتاته بأزمته النفسية بجميع تفاصيلها وباح لها بكل مخاوفه وأوهامه، وأصغت الفتاة إليه بقلب واع، ولكنها لم تجد من نفسها استعدادًا لتصديقه أو موافقته علي ظنونه وتقديراته، وأبت أن تسلم بما يسلم به قانطًا، وحملته علي عرض نفسه علي مشاهير الأطباء، ولم تدعه يذهب وحده فذهبت معه.. وأكد الأطباء جميعًا وجود الضغط ولكنهم سخروا من أوهامه وأجمعوا علي أن لا خطر يهدده قبل الستين.. وابتسمت إحسان مغتبطة وابتسم محمد في حيرة وارتياب، وظل علي ارتيابه أيامًا ولكنه كان شديد الاستعداد للتأثر والإيحاء فأخذت كلمة الثقات تمحو من نفسه المخاوف، ولكنه لم يعاوده شعور الطمأنينة |

|
|
|
#6 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
إلي الحياة والنجاة من الموت إلا بعد أيام أخري.. فلما كرت ذهبت عنه حمي الخوف وعد نفسه مرة أخري من الأحياء، وتأمل حياته ساعة فلم يتمالك أن يهتف من أعماق قلبه: يا عجبًا.. لقد بعثت بعثًا جديدًا.
لأنه مات ـ إذا جاز لنا أن نقول ذلك ـ ذليلاً جبانًا سارقًا نذلاً أعزب، ورد إلي الحياة كريمًا شجاعًا أمينًا شهمًا متزوجًا ـ فياللعجب! هل يستطيع الموت أن يخلق جميع هذه المعجزات؟ لقد غابت عنه قديمًا لذة الفضيلة فكبر عليه فعل الخير وهالته الشجاعة وخال الإقدام عليها هلاكًا ذريعًا.. فأثبت له الموت بالتجربة الواقعة أن الفضيلة سامية، وأن فعل الخير سعادة لا تعجز طالبه، وأن الشجاعة حياة كريمة لا هلاكًا محتومًا. ولا نحب أن نقدر محمدًا بفوق ما يستحق فالحق أنه كانت تأتي عليه ساعات يخلو فيها إلي نفسه فيهمس حيران متأسفًا: قد تزوجت وانتهيت.. وهجرت حياة الليل اللذيذ.. ولن أكون آمنًا بعد اليوم في وظيفتي.. ولكنها كانت أصواتًا خافتة سرعان ما تغيب في جلبة الحياة الجديدة.. ولبث يعجب لما صنع الموت منه.. ويحسبه من الخوارق والمعجزات.. ولما امتلأ صدره بالتعجب والتأمل رأي أن يشرك في أفكاره صديقه الطبيب الذي لا يؤمن بغير العلم والمادة فقص عليه قصته وروي له ما فعلته فكرة الموت بحياته، وأصغي إليه الطبيب بانتباه، فلما انتهي قال له بسخرية: «ويحك أتتوب عن نعيم الدنيا لدنو الموت منك؟ انظر إلي.. ألست تراني أواصل الليل بالنهار عملاً واجتهادًا وراء المجد والشهرة والنجاح؟ أتعلم ما الذي أصنع لو اطلعت علي الغيب وعلمت أن الموت مني قريب؟.. لا شيء.. أخلد إلي الراحة والدعة وأقضي ما بقي من حياتي بين الكاس والخدود!» وضحك ضحكًا عاليًا متواصلاً، ثم قال بنفس اللهجة الساخرة: «ولكن أتعلم متي أتوب حقًا عن المهالك وأهب نفسي للعلم والفضيلة؟ إذا وجدت الخلود ممكنًا في هذه الدنيا».. وأصغي إليه محمد في صمت وجمود... وازداد عجبًا وتأملاً... |

|
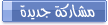
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 17:12 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)




